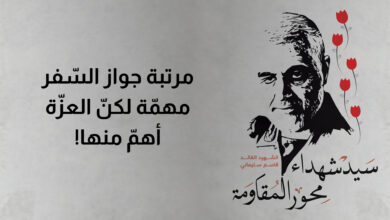جدول المحتويات
يقول أمير المؤمنين (ع): «فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ ومَرَقَتْ أُخْرَى و[فَسَقَ] قَسَطَ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ [حَيْثُ] يَقُولُ <تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ ولا فَساداً والْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ>[1] بَلَى واللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا ووَعَوْهَا ولَكِنَّهُمْ حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ ورَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا[2]»[3]
طلب العلو والإفساد في الأرض!
المارقون والقاسطون والناكثون، أوجهٌ متعددةٌ، ومشارب متفرقةٌ، وآراء متباينةٌ، وميولاتٌ وأهواءٌ متناقضةٌ، هذا بحسب الظاهر وبالنظر الأولي البدوي والنظرة السريعة غير العميقة!
إلا أنّك إذا تعمقت في الأمر وتجاوزت القشر والظاهر ووصلت إلى اللّب والباطن، وأعدت النظر مرة بعد أخرى، لأتضح لك شيء آخر، وأنّ هذه أوجه متعددة لعملةٍ واحدة!
فهناك ما يجمعهم ويوحدهم على الاصطفاف ضد الإمام علي (ع)، ومحاربة الحق ومناجزة راية الهُدى، إنه طلب العلو في الدنيا والإفساد فيها!
حب الدنيا رأس كل خطيئة!
لقد كانوا يلهثون وراء المنصب والرئاسة والزعامة، ويعشقون الكرسي والإمرة، ويتناحرون من أجل السيادة والتحكم على رقاب العباد، فالدنيا قد حليت في أعينهم، فأخذت بشغاف قلوبهم، وأعمت أبصارهم وأسكرتهم فجعلتهم يتيهون: فلا يبصرون طريقاً ولا يهتدون سبيلاً!
فقد كانت «الدنيا» هي المعشوق لهم والمهوى لأفئدتهم، وكانت الدنيا كل آمالهم!
والحال أن الدنيا رأس كل خطيئة ومصيبة وفاجعة! وأول فجائعها: أن تسلم الانسان دينه وايمانه وعقله! وهكذا خدعتهم الدنيا وغرّتهم، ووثقوا بها فصرعتهم! حتى وصلوا في آخر المطاف إلى حرب مولى الموحدين وأمير المؤمنين (ع) والذي لولاه ما قام الدين! فسقطوا في وادي الضلال وارتحلوا إلى نيران الخالدات!
وإنما بدأ وقوع الفتن أهواء تتبع!
فهم -المارقون والقاسطون والناكثون- لم يعيشوا الدّين إلا ظاهراً ولم يلتزموا بالإسلام إلا نفاقاً ولم يعبدوا الله إلا كرهاً، فقد كانوا يعيشون قشور الإسلام ويكتفون بظواهر الأحكام ولم يوصلوا إلى قلوبهم حاق الإيمان!
فكان ما كان: أن سفكوا الدماء، وهتكوا الأعراض، ونهبوا الأموال، وعاثوا في الأرض الفساد!
والأدهى والأمر من فعالهم: أنهم زعزعوا دولة العدل الإلهي، وفوّتوا على الإسلام والمسلمين أفضل فرصة نورانية انشر الإسلام الأصيل فيها بيد أمير المؤمنين (ع)!
كلُّ ذلك بسبب أطماعهم وأهوائهم وشيطنتهم، ونتيجة جهلهم وضحالة أفكارهم.
يقول أمير المؤمنين (ع): «إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وأَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ ويَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ»[4]
حاربوا علياً لأنه يهدد دنياهم!
ما كانوا يجهلون علياً (ع) ولا علمه ولا عدله ولا كل فضائله!
وما كانوا يشكّون في أنّه الخليفة الحق، فهم على يقين من كل ذلك!
ومع كل ذلك حاربوه وعادوه وناجزوه؛ لأنّه كان يهدد دنياهم الفتون ومعشوقهم الظلوم!
وحب الشيء يعمي ويصم؛ وقد أعمتهم الدنيا وأصمتهم الآمال، فغدوا صرعى الشهوات وأسرى الرغبات، فقد صرعتهم الشهوات قبل أن تأخذ السيوف أرواحهم، وقتلتهم الأماني قبل أن يخطف الموت أنفاسهم!
نعم، لقد ماتوا قبل أن يموتوا؛ ماتت أرواحهم وزالت القيم عنها وانمحت عناصر الخير منها.
ومن ثم تم الاجهاز على أجسادهم وأبدانهم! فـ «أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِع»[5] «والْأَمَانِيُّ تُعْمِي أَعْيُنَ الْبَصَائِرِ» [6].
الدنيا تتلون لأبنائها فتخدعهم!
وهكذا الدنيا، تأتي إلى كل شخص وإلى كل صنفٍ من الناس باللون والشكل الذي يمكن أن تخدعهم وترديهم وتصرعهم، فهي -الدنيا- تُجهز على الجميع بمختلف ألاعيبها وأصناف حيلها: فمنهم من «ناكث» ومنهم من «قاسط» ومنهم من «مارق»! فكلهم أبناء الدنيا وكلهم قتلالها، ولأجلها حاربوا علياً (ع).
قال أمير المؤمنين (ع): «أَنَا حَجِيجُ الْمَارِقِينَ وخَصِيمُ النَّاكِثِينَ الْمُرْتَابِينَ وعَلَى كِتَابِ اللَّهِ تُعْرَضُ الْأَمْثَالُ وبِمَا فِي الصُّدُورِ تُجَازَى الْعِبَاد»[7]
«لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ (ص) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ ولَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وعِمَادُ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي وبِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي ولَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ والْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ ونُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِه»[8].
فالكل يزعم -بقتالهم للإمام علي (ع)- أنّهم طالبون للحق ناصرون له!
أولاً: مع الناكثين و«حزب الجمل»
كانوا من السابقين!
طلحة والزبير، كانا من السابقين في دخول الدين، وتحمّلا من أجله أصنافاً من الأذى صابرين محتسبين، وقارعوا وصمدوا أمام ترهيب القرشيين، في تلك الأيام الشداد وعندما كان الإسلام غريباً وحيداً يعاني قلّة المسلمين وكثرة المعاندين!
عاينوا ظلامات إخوتهم وكيف أنّ صناديد قريش يسومونهم سوء العذاب: يقتلون ياسر وزوجه ويعذّبون عماراً وبلالاً! فقد كانت القسوة بادية والثبات مستميتاً، والبلاء عظيماً والصبر جميلاً!
هكذا كانت بدايتهم ولكن كيف صارت خاتمتهم؟!
لأنهم كانوا مع الله!
طلحة والزبير عاشا تلك الأجواء وصبرا على تلك الصعاب وتحمّلا أصناف العذابات! لأنّها كانا يرجون «الله».
بذلا ما كانا يملكان ونظرهما متوجهً نحو «العقبى» معرضاً عن «الدنيا»، فكان ذلك الثبات وتلك الاستقامة على طريق ذات الشوكة!
وهكذا تصمد النفوس وتثبت الأقدام وتطمئن القلوب، ويعقب كل ذلك سعادة في الدنيا وفلاح في الأخرى.
وكما يقول الإمام علي (ع): «أَلَا وإِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمْ تَضْيِيعُ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ بَعْدَ حِفْظِكُمْ قَائِمَةَ دِينِكُمْ، أَلَا وإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ»[9].
طريق ذات الشوكة والمنزلقات!
وطريق ذات الشوكة يحتاج إلى الاستقامة على الهدى، ومراقبة النفس من أن تزلّ فتردى!
وأصعب ما في ارتياد «طريق الهدى» و«سبيل الإيمان» و«العبور على الأشواك»: هو الثبات وعدم التراجع والانهزام؛ فقد يصمد الإنسان في أولى الساعات والأيّام والسنوات إلا أنه يتعثر أو يسقط مع كثرة المنزلقات وشدّة العَقبات وتطاول الزمان، ومع تنوع الفتن وتتابع الاختبارات والمحن! حتى يحصل الانقلاب على الاعقاب وتهديم كل ما شيّد من بناء، ومن ثم الهوي في النيران!
يقول الإمام علي (ع) وهو يشكو من فعل طلحة والزبير ومن سار في ركابهما: «فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّالِي وخُزَّانِ بَيْتِ [مَالِ] الْمُسْلِمِينَ الَّذِي فِي يَدَيَّ وعَلَى أَهْلِ مِصْرٍ كُلُّهُمْ فِي طَاعَتِي وعَلَى بَيْعَتِي فَشَتَّتُوا كَلِمَتَهُمْ وأَفْسَدُوا عَلَيَّ جَمَاعَتَهُمْ ووَثَبُوا عَلَى شِيعَتِي فَقَتَلُوا طَائفَةً منْهُمْ غَدْراً و[طَائفَةً] طَائفَةٌ عَضُّوا عَلَى أَسْيَافِهِمْ فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ صَادِقِين»[10]
من حب الله إلى حب الدنيا!
إنّ أعظم سبب لكلّ الانزلاقات وأخطر شيء بسبب تضييع المكتسبات بل السبب المحوري لكل الانحرافات هو «حبّ الدّنيا» والارتماء في اللذائذ والشهوات والاغترار بالمال والجاه والحطام، فـ«حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»[11]!
وعندما يفرغ القلب من «حبّ الله» ويضع محله «حبّ الدّنيا» فعندها سوف يتغير «المسار» بعد أن تغيرت قِبلة الفؤاد وسوف تذهب تلك التضحيات أدراج الرياح بفعل العواصف العاتية للأماني والمشتهيات التي لا تبقي ولا تذر شيئاً من الجهود والإنجازات، يقول الإمام علي (ع): «وَإِنَّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا»[12].
وهكذا خسروا!
وهكذا خسر طلحة والزبير وأمثالهما؛ فبعد كل تلك التّضحيات والصّبر على طول المعاناة والبذل في خدمة الإسلام، وبسبب الوقوع في شراك الدنيا والانخداع بزخرفها وزبرجها واللهث وراء حطامها، وإرادة العلو والإفساد فيها .. فإنّهما دمّرا كلّ ما أنجزاه واحرقا كل ما جمعاه، فكانت الخاتمة السيئة والعاقبة المظلمة وخسران الدنيا والآخرة!
يقول أمير المؤمنين (ع) وهو يظهر عذره في قتال أصحاب الجمل: «فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) كَمَا تُجَرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا وأَبْرَزَا حَبِيسَ[13] رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَهُمَا ولِغَيْرِهِمَا فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وقَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ وسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وخُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً وطَائِفَةً غَدْراً فَوَاللَّهِ [إِنْ] لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ بِلَا جُرْمٍ جَرَّهُ لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا ولَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ ولَا بِيَدٍ دَعْ مَا [إِنَّهُمْ] أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِم»[14]
قصة طلاب الرئاسة في كل الأزمان!
لقد بايع طلحة والزبير علياً (ع) طمعاً بولاية الكوفة والبصرة، لكنّهما لما رأوا ثبات علي (ع) في دينه وعزيمته الراسخة التي لا تلين ووجدوا أن علياً مُصمم على أن يؤسس مسار حكومته على أساس الكتاب وسنة النبي (ص) تمرّدا عليه!![15]
فقد استولى حبّ الجاه والرئاسة على قلبيهما، فصموا وعموا وتخبّطوا في الظلمات!
يقول أمير المؤمنين (ع): «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجُو الْأَمْرَ لَهُ ويَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ لَا يَمُتَّانِ إِلَى اللَّهِ بِحَبْلٍ ولَا يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبٍّ[16] لِصَاحِبِهِ وعَمَّا قَلِيلٍ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ واللَّهِ لَئِنْ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا ولَيَأْتِيَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا»[17].
نعم «فهذه هي قصّة طلاب الرئاسة على الدوام، فمعبودهم الرئاسة الرئاسة وكفى! وهم يضحون بكل شيء في سبيلها»[18].
ثانياً: مع القاسطين و«حزب صفين»
ما أسلموا ولما وجدوا أعواناً أظهروا الكفر!
معاوية بن أبي سفيان، هذا الذي أخذ الشيطان منه مأخذه وبلغ فيه أمله وجرى منه مجرى الروح والدم! المختلف العلانية والسريرة، المتمادي في غِرَّة الأمنية، ما أسلم ولكنه استسلم وترك الإسلام طائعاً ودخل فيه كارهاً! عاش كافراً وبقي منافقاً!
يقول أمير المؤمنين (ع): «فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا ولَكِنِ اسْتَسْلَمُوا وأَسَرُّوا الْكُفْرَ فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أَظْهَرُوه»[19].
فـ«معاوية» لم يُسلم بقلبه وإنّما أسلم بلسانه فقط خوفاً من القتل وقد أسرَّ الكفر فلما وجد عليه أعواناً وأنصاراً: أظهر الكفر الذي كان مستوراً وحارب الإسلام قتالاً مستميتاً!
قائدهم معاوية ومؤدبهم ابن النابغة!
معاوية بن أبي سفيان .. يعلنها اليوم حرباً على علي (ع) ويرفض بيعته ولا يراه خليفة شرعياً! ويتّهمه بأنه يحمي قتلة عثمان وهو ولي دمه والطالب بثأره!!
وهكذا تفعل الدنيا بأولادها ومن يسكر في هواها: تطير عقولهم وتسلب ألبابهم فلا تجعلهم يهتدون لحجة ولا ينطقون بمنطق وعقلانية!
فهم يهذون ويشرّقون ويغرّبون تائهين في الظلمات، ظلمات الجهل والضغائن واللهث وراء الشهوات، وهي ظلمات بعضها فوق بعض، لا يهدي من وقع فيها ولا يقدر على الخروج منها!
يقول أمير المؤمنين (ع): «وَأَقْرِبْ بِقَوْمٍ [20]مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ ومُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَة»[21].
فإذا كان الرئيس القائد هو معاوية والمؤدب ابن النابغة وهما أئمة الغدر والخداع والجهل والبعد عن الله تعالى، فما هو حال الأتباع لهما؟! إنّه بعدٌ عن الله تعالى وجهلٌ به وحربٌ لأوليائه وأحبّائه!
معاوية يغدر ويفجر!
إنها الدنيا مرة أخرى، تزينت لمعاوية وحزبه، حزب الكفر والنّفاق وتلونت لهم هذه المرة بـ«قميص عثمان» يرفعونه ويتباكون عليه من أجل أن يصلوا إلى دنياهم الفتون!
نعم، رفعوا شعار المظلومية ولكن ليظلموا وتباكوا بالمقهورية ليقهروا! ودعوا لإقامة القسط لأجل أن يجوروا!!
إنّها الدنيا إذا راقت لعشيقها ولهث الحبيب في هواها: حيث لا تجعله يُبصر وتسكره فلا تتركه يرشد، فهو لا يبصر إلا الشهوات والأماني والنّزوات ولا يسمع إلا الملاهي والموبقات!
يقول أمير المؤمنين (ع): «وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي ولَكِنَّهُ يَغْدِرُ ويَفْجُرُ ولَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ ولَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وكُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ ولِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ واللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ ولَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَة»[22].
حارب علياً ظلماً وعلواً!
ومعاوية .. كان يعرف من هو الإمام علي (ع) فهو من الذين لا تخفى عليهم مكانته ومنزلته في الإسلام، ولكن ماذا يؤثّر هذا العلم في معاوية عدو الإسلام الأول: الذي خلع لباس الكفر وارتدى لباس النفاق من أجل أن يطمس معالم الدين!
وماذا يعني لمعاوية شأن الإمام علي (ع) الرفيع وهو الذي ما فتئ ليلاً نهاراً على إطفاء نور الهداية النازل من رب العالمين، حتى قالها صراحاً جهاراً: دفناً دفناً!!
واستمع إلى أن الأمير (ع) وهو يتظلم ويشتكى من قريش: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ ومَنْ أَعَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِي وصَغَّرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِيَ وأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُوَ لِي ثُمَّ قَالُوا أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وفِي الْحَقِّ أَنْ تَتْرُكَه»[23].
إنه قلبٌ قسى وروحٌ أظلمت ونفسٌ خبثت، وهو رأس الكفر والنفاق، معادٍ لأهل التقوى والإيمان؛ وكيف لا يعادي معاويةُ علياً (ع) وهو الطهر والنور وأساس الإيمان؟!
يقول الأمير (ع): «وَدَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ *** ولَكِنْ حَدِيثاً مَا حَدِيثُ الرَّوَاحِلِ
وهَلُمَّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْكَائِهِ ولَا غَرْوَ واللَّهِ فَيَا لَهُ خَطْباً يَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ ويُكْثِرُ الْأَوَدَ[24] حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ اللَّهِ مِنْ مِصْبَاحِهِ وسَدَّ فَوَّارِهِ مِنْ يَنْبُوعِهِ وجَدَحُوا[25] بَيْنِي وبَيْنَهُمْ شِرْباً وَبِيئاً فَإِنْ تَرْتَفِعْ عَنَّا وعَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوَى أَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى <فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُون>»[26]
حزب الشيطان لا يكفّ عن مناجزة حزب الله!
إنّه «حزب الشيطان» الذي لا يكفّ عن مناجزة «حزب الله» في كل زمان ومكان! فهي حربٌ ضروس بينهما ما دامت السماوات والأرضون؛ فأبناء الدنيا وأبناء الآخرة، وحزب الشيطان وحزب الله، لا يمكن أن تخلو منهم الأزمان والأوطان: فلكل فرعون موسى ولكل نمرود إبراهيم ولكل معاوية علي!!
فلنفتّش في الزمان الذي نعيشه والمكان الذي نستوطنه: فنشخّص معاوية الزمان وعلي المكان ونتخذ الموقف الإيماني: بالوقوف مع علي وحزبه «حزب الله»، والموقف ضد معاوية وخزبه «حزب الشيطان»!
وهذه الحرب الضروس دائمة الاستشعار حتى قيام الإمام المنتظر(عج) وقيام الدولة العالمية، وعندها تكون كلمة الله هي العليا، بلا شريك ولا منازع، وتكون الحكومة للمستضعَفين والمظلومين، والعاقبة للمتقين!
ثالثاً: مع الخوارج و«حزب النهروان»
عاشوا جهّالاً وماتوا ضلالاً!
الخوارج .. أصحاب الجباه السود، القائمون بالأسحار، التالون للقرآن، الذين خدعوا الناس بتنسّكهم، وغرّوا الجهال بعبادتهم، الذين لم تتجاوز آيات الكتاب تراقيهم، ولم تُنر المناجاة قلوبهم، ولم تُلن العبادة قلوبهم!
هؤلاء وقفوا في حربٍ طاحنة دامية أيضاً في وجه إمام الحق وخليفة الله في السماء والأرض! وقد كانوا مورداً لشكوى الإمام (ع) بسبب جهلهم وضلالهم: «إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّالًا ويَمُوتُونَ ضُلَّالًا لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ولَا سِلْعَةٌ أَنْفَقُ بَيْعاً ولَا أَغْلَى ثَمَناً مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ولَا عِنْدَهُمْ أَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ ولَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَر»[27].
فمن يعيش جاهلاً فسوف يموت ضالاً منحرفاً عن الصراط المستقيم، ولن يصل إلى الغاية والكمال والسعادة! وإذا فُسّر الكتاب وحُمل على الوجه الذي أنزل كما فسّره لهم الإمام علي (ع) فإنّهم لا يقبلونه ولا يأخذون به بل يعتقدونه فاسداً ويطرحونه بجهلهم!
أمّا إذا حُرّف الكتاب عن مواضعه ومقاصده، ونزل على حسب أغراضهم وأهوائهم ومقاصدهم، فإنّهم يشرونه ولو بأغلى الأثمان، وكان أنفق سلعة بينهم!
و«المعروف» إذا خالف أغراضهم وأهوائهم فإنّهم يطرحونه ولا يأخذون به، بل يصير عندهم منكراً يستقبحون فعله!
و«المنكر» الذي يتوافق مع أغراضهم يأخذون به حتى يصير عندهم معروفاً يفتخرون بفعله!!
غرهم الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء!
الخوارج .. القشرية في فهم الدين والنظرة الضيقة والمعوجّة للحياة مضافاً إلى العصبية والغرور والكبر والحمية والاغترار والاعتزاز.
يعيشون الجهل العلمي والجهالة العملية: فهم أذنٌ صاغية للأكاذيب والألاعيب الشيطانية: فتارة يقعون في مكيدة المصحف العاصية وأخرى يرتمون في وحل الأموال الأموية!
والأعجب من كل ما تقدم: أنّهم لا يرضون بأن يعيشوا الجهل والجهالة والضلال والغواية في حياتهم الشخصية فحسب، بل يصرّون على جبر الآخرين بأن يسيروا كما ساروا ويعيشوا كما عاشوا؛ فقد اعترضوا على أمير المؤمنين (ع) وحاربوه لأجل ذلك -أن يسير في ركابهم ويمشي خلفهم ويطيع أمرهم!!-.
وهكذا الجهل وخساسة النفس وما تفعلان في صاحبها، بل وهن يعيش قريباً ممن ابتلي بهما!!
«وَقَالَ الإمام علي (ع) وقَدْ مَرَّ بِقَتْلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ: بُؤْساً لَكُمْ لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ غَرَّهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: الشَّيْطَانُ الْمُضِلُّ والْأَنْفُسُ [النَّفْسُ] الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، غَرَّتْهُمْ بِالْأَمَانِيِّ وفَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَعَاصِي [فِي الْمَعَاصِي] ووَعَدَتْهُمُ الْإِظْهَارَ فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّار»[28]
فما كان قتالهم وتقديم دمائهم من أجل الدين ورفع راية الإسلام، بل لأجل الدنيا؛ فالأماني بالغلبة والقهر والانتصار؛ ومن ثم الحصول على الرئاسة والجاه، كان الدافع لقيامهم والأماني هي تفسح لهم في ارتكاب المعاصي وتحلل لهم الحرام وتجرؤهم على اقتحام المحظورات وتزين لهم القبائح والموبقات!
ونتيجة هذه الأماني ان تقحموا في النيران؛ بعد ان نغصوا الحياة على الأبرار!
نصبوا الناس أشراكاً من حبائل غرور!
والخوارج، قد حسبوا أنفسهم علماءاً وسائر الناس جُهّالاً، وتوهموا أنّهم مع القرآن وباقي الخلق ضدّه، وتخيلوا أنّهم مع الحق في إيقاف الحرب بعد أن رُفعت المصاحف وغيرهم على باطل.
وهكذا كانوا: هم فقط وغيرهم لا! فلا هم يفهمون ويعون ولا يريدون أن يفهموا ويعوا، بل هم غير قادرين على فهم ووعي ما حولهم من الأساس!
وهم في كل يوم في ظلمة ومع كل ابتلاء في فتنة، يسيرون فيتعثرون ويقعون فلا يتمكنون من النهوض والقيام! ومع كل ذلك لا يكتفون إلا بأن تقبلهم الأمة وتسمع لهم، بل لابد أن تسير خلفهم وتتابعهم في جهلهم وجهالاتهم وضلالهم وتخبطهم!!
يقول الإمام علي (ع): «وَآخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً ولَيْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ وأَضَالِيلَ مِنْ ضُلَّالٍ ونَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وقَوْلِ زُورٍ قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ وعَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِهِ يُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ ويُهَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ.
يَقُولُ: أَقِفُ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ، وفِيهَا وَقَعَ! ويَقُولُ: أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ، وبَيْنَهَا اضْطَجَعَ!
فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ والْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَيَتَّبِعَهُ ولَا بَابَ الْعَمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ وذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء»[29]
فهم قد يتسمّون ويدّعون شيئاً ولكن واقعهم وحقيقتهم في الجهة المقابلة والمناقضة لما يدعون!
فهم لم يقتبسوا علماً ولا اهتدوا طريقاً، وإنّما اقتبسوا جهلاً وسادوا ضُلّالاً! ولم يرضوا بأن ضلوا بل أصروا على أن يضلوا فنصبوا أشراكهم على طريق السائرين للكمال، يقطعون الطريق عليهم ويأخذونهم في ظلماتهم!
يدعون الناس بأن يرجعوا للقرآن، لا لأجل أن يسيرا في هديه بل لأنهم سيتمكنون ومن خلال القرآن -وبعد أن حملوا آرائهم عليه وفسروه بأهوائهم- أن يحرفوا الناس ويجعلونهم يسيرون خلفهم.
فهم حملة القرآن ومفسروه! يقولون: نقف عند الشبهات ولا نقدم عليها، ولكنّهم يقعون فيها لجهلهم بمواقع الشبهة وغيرها! ويقولون: نعتزلُ كل ما يخالف قوانين الشرع، والحال أنّهم متورطون فيها لجهلهم بأصول الشريعة!
وهذا هو حالهم، لا يعرفون بجهلهم قانون الهداية إلى طريق الحق فيسلكونه ولا وجه دخول الباطل فيعرضون عنه!
يعيشون جهلاً مركباً وجهالة مظلمة؛ لأّن الحياة الحقيقية هي حياة النفس باستكمال الفضائل التي هي بسبب السعادة الباقية، والجهل المركب الذي يعيشونه هو الموت المضاد لتلك الحياة، فالجاهل بالحقيقة ميّت! وهو ميت الأحياء: فلأنه في صورة الحي![30]
عاشوا أمواتاً وأماتوا أحياءً!
وتبقى الدنيا السبب الرئيس لشقاء مثل هؤلاء وعنائهم، فبحبّها وبالانغماس في لذائذها والاعراض عمّا سواها، جعلهم يقفون في مقابل الحق ويحاربون إمام الحق!
والدنيا تتلون بما يروق لطالبها: فهي قد تلونت لـ«الخوارج» بالعبادة وقيام الليل وتلاوة القرآن! تلونت لـ«الخوارج» بالدّعوة للوحدة ولمّ شمل المسلمين وعدم التناحر والاقتتال وسفك الدماء، كما فعلوا في صفين!
وهكذا تتلون الدنيا فتغمسهم في الأكاذيب وتعميهم بالأضاليل، وتأخذهم من وادٍ مظلمٍ إلى آخر سحيق! وهكذا أنِسَ «الخوارج» بالدّنيا: فشربوا من كدر حطامها ووحل زخارفها وهم معجبون بها ومستقرين في أحابيلها!
حتى تمادوا في غيّهم وتجاوزوا حدودهم بعد أن عميت أبصارهم وأظلمت وقست قلوبهم: فهدّدوا علياً (ع) ثم حاربوه ثم قتلوه!
إنّها الدنيا وفعالها وما تصنع في من يحبّها ويقدمها على ما سواها: فهي تُهلك من لا يعرفها وتقتل من لا يفقهها، وتجهز على طالبها والمغتر بها!
وهكذا قتلت الدنيا «الخوارج» وأردت أرواحهم إلى سواء الجحيم، لكن بعد أن فضخوا رأس أمير المؤمنين (ع)!!
يقول الإمام علي (ع) وهو يصف الدنيا وما تفعله في أحبائها والمنخدعين بها: «فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ[31] مَشْرَبُهَا رَدِغٌ[32] مَشْرَعُهَا يُونِقُ مَنْظَرُهَا ويُوبِقُ[33] مَخْبَرُهَا غُرُورٌ حَائِلٌ[34] وضَوْءٌ آفِلٌ وظِلٌّ زَائِلٌ وسِنَادٌ مَائِلٌ، حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا واطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وقَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا وأَقْصَدَتْ بِأَسْهُمِهَا وأَعْلَقَتِ الْمَرْءَ أَوْهَاقَ الْمَنِيَّةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ ووَحْشَةِ الْمَرْجِعِ ومُعَايَنَةِ الْمَحَلِّ وثَوَابِ الْعَمَلِ.
وَكَذَلِكَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّلَفِ لَا تُقْلِعُ الْمَنِيَّةُ اخْتِرَاماً [35] وَلَا يَرْعَوِي الْبَاقُونَ اجْتِرَاماً[36] يَحْتَذُونَ مِثَالًا ويَمْضُونَ أَرْسَالًا إِلَى غَايَةِ الِانْتِهَاءِ وصَيُّورِ الْفَنَاء»[37]
خطر القشريين على المجتمعات!
ولا يخلو أي مجتمع من أمثال هؤلاء القشريين الجهلة: الذين يقصمون ظهور المصلحين بتنسكهم الجاهل، ويشغلون أفكار الناس ويرهقونهم بضعف عقولهم وخواء آرائهم وعمش بصائرهم!
هذا مضافاً لاتصافهم برذائل الأخلاق وقسوة الطباع من تعصب وعناء ولجاج! فهم في صفوف المصلين يدعون للفحشاء والمنكر!
وممن يقومون الليل ويتهجدون في الأسحار، وكان ذلك سبب هلاكهم!
ويُعدّون من أهل الورع والاجتهاد والزهد، والحال أنّهم في الدنيا منغمسين وخلف شهواتها لاهثين، بل فاقوا حتى الذين هم في القصر وساكنين!
فهي الدنيا، وقد تلوّنت لهم بهذا اللباس: حيث تخلوا عن الأكل والشراب وجميع الثروات، إلا أّنهم ابتلوا بالاعتداء على النفس وعبادة الذات والعجب والرياء والتظاهر بالقداسة والصلاح!
وهكذا ملكت الدنيا قلوبهم وافرغتها من حب خالقهم «حب الله»، فصاروا من أبناء الدنيا وهم لا يشعرون!
داعش .. خوارج هذا الزمان
تمهيد
إنّ الأمة الإسلامية قد تواجه «عدواً خارجياً»، يهدد وجودها ويزعزع أمنها ويسعى لسلب ثرواتها واحتلال بلادها، فتعدّ الأمّة العدّة والعتاد لقتاله وتمنعه من الوصول إلى مناله.
وهذه حربٌ ظاهرة المعالم، بيّنة الأهداف، مكشوفة الأعداء!
وقد تواجه الأمّة الإسلامية عدواً أخفى وأخطر من ذلك العدو الخارجي، إنّه «العدو الداخلي» الذي زُرع -ككيان غريب- في وسط الأمة، وأُلحق به بعض الغرباء اللقطاء ممن جيء بهم من مختلف الدول والبلدان!
فهم يرفعون راية الإسلام، ويدّعون للخلافة وحكومة الملك الدّيان، والحال أنّ الذي أنشأهم ومن ثم تكفل بتربيتهم هم أعداء الإسلام والعدو الخارجي لأمة القرآن!
فماذا سيحمل اللقيط وبم سيفكر العميل، ما هي أهداف الأجير؟
إنّها الحربٌ على الإسلام باسم الإسلام، وتحقيق لأهداف الشيطان على عباد الرحمن، والتفكير بالقضاء على الأوطان امتثالاً لما يمليه عليهم عبدة الأوثان!
وأمريكا «الشّيطان الأكبر» ومن عاضدها من دول الاستكبار العالمي، هم أعداء الشعوب، وأساس الحروب، وموقدوا الفتن من أجل دنياهم الغرور!
فهم يسعون للهيمنة على مقدّرات البشرية، وبالأخص الدول الإسلامية الغنيّة، لا يهدؤون ولا يفترون، ويختلقون الأكاذيب ويشغلون الحروب، ويهدفون من كل ذلك تحقيق أطماعهم وتحصيل آمالهم، ولو سيراً على جثت الأطفال وجماجم النساء وبرك الدماء!
والاستكبار العالمي وعلى رأسهم الأمريكان والصهاينة عندما وجدوا الممانعة من بعض الدول الإسلامية، وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية: حيث لم تقبل بالدنية، ولا الركوع والخضوع وطاعة شر البريّة، بل اختارت الحياة العزيزة الأبية.
وبعد أن وجد نفسه -الاستكبار العالمي- ضعيفاً عن المواجهة وجهاً لوجه في الحروب العسكرية، وبعد تلك الضربات القوية التي لاقاها من أبناء المدرسة الكربلائية العاشورية في أفغانستان والعراق ووسوريا ولبنان الأبية!
عندها فكّر بأسلوبٍ آخر في المواجهة الفكرية والعسكرية: حيث رجع إلى التاريخ الإسلامي في أول بداياته، وفتش في نقاط قوته وضعفه، وسلّط نظره إلى أعدى أعدائه، فلم يجد -لتحقيق أهدافه- أفضل من متحجري العقول وقساة القلوب!
فأخرج «الخوارج» -وفكره الرجعي التكفيري القشري- من طي النسيان وجعله واقعاً يعيث فساداً في الأوطان؛ فربّى أمثال «ابن لادن» و«الزرقاوي» و«البغدادي»، والقائمة تطول وتطول!
وأنشأ الكيانات الغريبة اللقيطة وزرعتها في قلب العالم الإسلامي: فبالأمس كانت «القاعدة» واليوم «داعش» وغداً؟! وإن غداً لناظره لقريب!!
وعلى الأمة الإسلامية جمعاء: أن تعي الأعداء، ما كان منها خارجياً أو داخلياً ظاهراً أو خفياً، فتعد نفسها للمواجهة ولا تقبل منهم بالمهادنة! وإن اختلف الأعداء في اللباس والفعال ولحن الخطاب! فهم أعداءٌ وسيبقون أعداءً!!
حربٌ ناعمة وأخرى عسكرية!
والاستكبار العالمي ينتخب الحرب المناسبة لتحقيق أهدافه؛ فتارة تكون «الحرب العسكرية»: يستعمل فيها أنواع السلاح ويرتكب فيها أفظع الجرائم على الأنام، كما فعلوا بالأمس في اليابان وفيتنام، واليوم في أفغانستان والعراق وسوريا وجنوب لبنان، بحجة الدفاع عن النفس وبذريعة القضاء على الإرهاب!
وتارة تكون الحرب ناعمة، هادئة، ومن غير جلبة ولا ضوضاء: حيث الاستحواذ على الفريسة بأخفى مكيدة، وأدهى حيلة!
ومن خلال بسطاء العقول ومرضى النفوس الذين يجعلهم العدو عوناً له على إخوتهم وأهل دينهم ووطنهم!
إنّها حرب -بما تحمله كلمة الحرب من معاني الدمار والفساد وسفك الدماء و…- تبدأ باختراق الفكر والعقيدة، وصياغة نهج ورؤية انحرافية: تقضي على الإسلام باسم الإسلام، وتذبح المسلم بيد أخيه المسلم، وتجعل الشعوب أسيرة للتهجّر والاغتراب والعيش تحت الانقاض لهثاً وراء سراب من الحطام!
إنّه «الإسلام الأمريكي» الذي يجعلك تقتل نفسك بنفسك، وتمكّن عدوك من احتزاز رقبتك، وتسفك دمك بثروات بلدك!
وهكذا بدأ المسلسل الإجرامي لـ«الاستكبار العالمي»: حيث أولدوا هذا اللقيط السلفي والمنهج التكفيري والإسلام الأمريكي، فرسموا كل معالمه وأكملوا جميع أحابيله ومخططاته، ثم زرعوه في وسط العالم الإسلامي، وسمّوه بمختلف التسميات، وها هم اليوم بجنون ثمار تلك الشجرة الخبيثة؛ فما من بلد إسلامي إلا وهذه الجرثومة تمرض ساكنيها وتذيقهم مرّ مآسيها!
وهكذا أراد «الاستكبار العالمي» أن لا تهنأ هذه الدول الإسلامية بأمن ولا أمان، فكان أفضل عونٍ لهم لتحقيق شيطنتهم: هم هؤلاء الخوارج .. عبدة الشيطان!
داعش وخيوط المؤامرة!
إنّ «الاستكبار العالمي» هو الذي صنع هذا الوجود اللقيط، وهو الذي انتخب مناهج عمله، واختار رجالاته، وخطّط لأفعاله!
وعليه: فمن المنطقي أن لا تحيد داعش عن تنفيذ ما يُملى عليها، ولا تحجم عن فعل ما يُطلب منها، خصوصاً في الخطوط العريضة والأهداف المحورية، الذي لا يضر -بعد أدائها- من تجاوز يحصل هنا أو زيغ يحصل هناك والاستكبار العالمي -وعلى رأسهم أمريكا- هم من يحدد الوقت المناسب والمكان اللازم لعمل القاعدة وداعش، فلا إرادة حرّة ولا استقلالية -لا في المنطلقات ولا في المسير ولا في الأهداف- لمثل هؤلاء الخوارج، بل هم تبع لهم وطوع لأمرهم!
وإن أراد الاستكبار العالمي أن يصوّر للعالم: أنه لا علاقة له بهم، بل أنّه يقوم بمحاربتهم ويسعى للقضاء عليهم، كما يرفعون مثل هذه الشعارات اليوم: حيث أحرقوا البلدان بحجة القضاء على الإرهاب!
فحتى يحقق الاستكبار أهدافه ويصل إلى مناله: لا بُدّ له أن يتبرأ من هؤلاء الخوارج، بل ويعمل على محاربتهم ظاهراً، ولكن بنحوٍ يقوّي وجودهم ويزيد من انتشارهم!
داعش واستنزاف الأمة!
و«الاستكبار العالمي» يحارب على أكثر من جبهة، ويسعى لتحقيق أكثر من هدف: فأعلى أهدافه هو أن يسيطر على كل مقدرات الشعوب، وأن تكون كل الأمم خادمة لمصالحه ومطيعة لأمره!
وهناك أهداف أقل رتبة من ذاك، وهي تسير في نفس مساره وتحطّ برحلها في الختام عنده: كإيجاد الاضطراب والحروب في البلدان والأوطان: فمع الحروب لا عمار ولا تنمية ولا بناء، ولا استثمار للعقول ولا تقدم ولا تفكير بتسلق القمم والجبال!
وبإيجاد الحروب بين الدول وتفرقها واشتغالها ببعضها البعض يتمكن الأعداء من السيادة والزعامة، كما قالوا: «فرّق تسُد»!
فـ«الاستكبار العالمي» لمّا وجد شدة بأس هذه الأمّة، بعد أن استيقظت من رقدتها وأفاقت من غفلتها، وبثت فيها روح الإباء ببركة «روح الله».
وبعد أن خاض الاستكبار بنفسه بعض الحروب، ومُني بالفشل والهزيمة النكراء، كما حصل ذلك في أفغانستان والعراق، وبعد النصر المؤزر لأبناء «روح الله» في حرب تموز في جنوب لبنان! فإنّه لم يجد بداً ولا حيلة من توجيه «الخوارج» للقضاء على الإسلام!
وهذه المرة انتهج خطة «الاستنزاف»: حيث يُشغل العالم الإسلامي بحروب طاحنة داخلية: بتمويل سعودي خليجي، وتخطيط أمريكي صهيوني على كل دول الإسلام، فتضعف كل الأطراف الإسلامية المتقاتلة -من كان على حق أو باطل- وتكون السيادة بعدها لأعداء الإسلام! والعدو ينظر ويتفرج: فلا المال ماله ولا الوطن وطنه ولا الشعب شعبه! فليحترق الجميع!!
والاستكبار ينتظر الفرصة للانقضاض!
وبعد كل هذه الحروب الطاحنة، والدماء القانية، والذهاب بمقدرات الأمة في حروب عابثة خائنة، وبعد إنهاك رجالها، وذبح نسائها وأطفالها، وبعد كل هذه الاستنزافات والجراحات للأمة الإسلامية الواحدة، يأتي العدو لينقضّ على فريسته المنهكة، فيوثقها ويقضي عليها!
والعدو هذه المرة لن يأتي باسم الاحتلال أو الانتداب، بل سيأتي باسم إحلال السلام ونزع فتيل النزاع وغيرها من المسميات!
وفي نهاية المطاف وبعد كل هذا النزف في كيان الأمة الإسلاميّة: فإنّه سيضّطر «أهل الحق» أن لا يقاوموا ويتريثوا قليلاً، حتى تضمد الجراح وتوقف نزف الدماء، مع أنّهم يرون كيف أن العدو يبسط نفوذه وسيادته على مقدرات الأمة! ولكن لا حول لهم ولا قوة بعد ان استُنزفوا بحرب العملاء وخوارج هذا الزمان!
لا خيار مع داعش إلا الحرب!
فداعش خوارج هذا الزمان، وعملاء الامريكان، وألعوبة الصهاينة الجبناء، لا يمكن للأمة الإسلامية أن تقبلهم وتعلن الصلح معهم؛ فهو وجود فاسد مُفسد، وضال مُضل، وغُدّة سرطانية لا بُدّ من اجتثاثها والتخلّص منها!
فهذا الوجود اللقيط ما أُنشأ وما رُبّي وما جيء به وزرع في العالم الإسلامي إلا من أجل تمزيقه وتدميره، ومن ثم السيطرة عليه من قبل أسياده!
فالحرب لا غير، وتطهير العباد والبلاد من أرجاسهم بأن يذاقوا سوء العذاب، وإزالة هذا الفكر الذي شوّه الإسلام وعاث في الأرض الفساد!
والحرب معهم وإن كانت شرسة ضارية، إلا أنّه لا خيار للأمة الإسلامية إلا ذاك! فالأمة الإسلامية: إمّا أن تقبل بهم، وهذا يعني قبولها للأسر والعبودية لهم وتسليم العباد والبلاد لأسيادهم! وإمّا أن ترفضهم وترفع راية الحرب ضدهم، وتؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام، وهذا هو خيار الكرماء!
من الإمام علي (ع) إلى القائد علي!!
وما أشبه اليوم بالبارحة، وآخر الدنيا لاحقٌ بأولها، وبعضها يشبه بعضاً!
فبالأمس لم يجد أعداء الإسلام -وعلى رأسهم حامل راية الكفر والنفاق معاوية ومستشاره ابن العاص- طريق لتقويض حكومة الإمام علي (ع) وزلزلة دولته وزعزعة خلافته خصوصاً بعد ما فشلوا في حرب صفين، إلا تحريك هذا العدو الخبيث «الخوارج»!
فقد كاد الأمير (ع) أن ينتصر في معركة صفين ويقضي على الكافرين القاسطين، فما كان بين مالك الأشتر والقضاء على رأس المنافقين معاوية إلا فواق ناقة، لو امهلوه قليلاً!
نعم، ما أمهلوه حيث حرّكوا العدو الداخلي وراهنوا على هذه الورقة لمثل هذه الورطة! فكان رفع المصاحف، وكان ابن النابغة يعلم بأن كيده سيفلح وخداعه سينجح؛ لأنّ سمّها الزعاف سينخر في جيش الإمام (ع) سواء أجمع الناس أم وقع بينهم الخلاف!
وهذا ما حصل، فمع أن «الخوارج» لا يمثّلون الأكثرية، إلا أن الظرف الخانق ووجود العدو الظاهر ووجود مثل هؤلاء البسطاء القشريين، مضافاً للمنافقين الذين باعوا الذمم، وغيرها الكثر!
فإن كلمة «الخوارج» صارت هي الماضية، وبالدّقة: فإن مَن وضع الخطة وحرّك الخوارج ودبر لحيلة رفع المصاحف هو المطاعة كلمته والنافذة أرادته!
وهل انتهت فتنة الخوارج بعد حيلة رفع المصاحف؟
كلا، بل ما كانت خدعة المصاحف إلا الشرارة لبدأ حراك الخوارج، فمنها بدؤوا، وهم سائرون إلى حربٍ دامية ضد الإمام (ع) في معركة النهروان، ولم تقف حتى فضخت هامة الإسلام في محراب الصلاة!
ففتنة الخوارج استنزفت دولة الإمام (ع) قبل أن يحاربوه وبعد ما حاربوه، فقد كانوا نعم العون لأعداء الإسلام على دولة الإسلام باسم الإسلام!!
والقصّة بنفسها تعاد حكايتها اليوم: فبالأمس الإمام (ع) واليوم القائد علي.
وبالأمس معاوية واليوم أمريكا، وبالأمس الخوارج واليوم القاعدة وداعش!
فبعد أن انهزم الامريكان، ورأوا شدة بأس أهل الإسلام: فمن النصر المؤزر لحرب تموز 2006 إلى الهزيمة النكراء لهم في العراق عام 2013، وغيرها من البطولات التي سطّرها عصائب أهل الحق وحزب الله وأنصار الله، والشبح المخيف للقائد الحاج قاسم سليماني، فإنّ الامريكان لم يجدوا من يعينهم على حرب الإسلام والقضاء عليه غير القاعدة وداعش .. خوارج هذ الزمان!
إنّها نفس الحكاية، والتاريخ يعيد نفسه، وإن اختلفت رجالاته؛ فالذي يقف اليوم سدّاً منيعاً ضد أطماع «الاستكبار العالمي» هو حلف الممانعة الذي تقوده الجمهورية المباركة!
والأعداء يدركون بأنّهم لن يقدروا اليوم على هزيمة القائد علي إلا كما قدر سلفهم الطالح على فضخ هامة الإمام علي (ع)، وأنّى لهم أدراك ذلك!!
إنّها القاعدة وداعش، خوارج هذا الزمان! فبنفس الحرب وبنفس المنهج والاسلوب يسير الخلف لتبع السلف!
نعم، إنّها نفس القصة والحكاية، يعيدها الاستكبار العالمي مرة ثانية: فالتاريخ يحكي أنّه ما إن قام الإمام علي (ع) وأنشأ دولته الفتيّة -هذه الدولة التي بثت الأمل مرة ثانية إلى الأمة الإسلامية، بعد الضياع الذي حلّ عليها 25 عاماً- حتى تحرّك الأعداء وانقضّوا عليه من كل جانب يحاربونه صبحاً وعشياً، فمن الناكثين وحرب الجمل، وإلى صفين ضد الحزب الأموي المنافق، وانتهاءً بحرب النهروان مع الخوارج!
نعم، لم يتركوا علياً (ع) وشأنه بل شغلوه بالحروب الدامية والغارات الخائنة والفتن المظلمة!
هكذا خطط الاستكبار الأموي وهكذا دبّر من أجل تفريق الأمة عن الإمام علي (ع)!
وبمثل هذه المكائد وصلوا، حتى خضبوا شيبته بدم رأسه! وبمثل هذه الأحداث تجري وقائع الأيام في مثل هذا الزمان؛ فما إن قامت دولة القائد علي، هذه الدولة الإيمانية التي بثت الأمل في كل الشعوب المستضعفة والمحرومة، بعد ضياع لحق بالأمة دام عدّة قرون حتى حرّك الاستكبار العالمي كل جنوده، ولعب بكل أوراقه من أجل أن يقضي على دولته وتخلو الساحة له!
فالاستكبار العالمي هو وراء تحريك الحروب الداخلية التي كانت تدعو للانفصال وقيام دولة عربية وأخرى كردية و…!
والاستكبار العالمي هو الذي أمر صدام العفلقي وحزبه الكافر أن يشن الحرب على دولة الإسلام، هذه الحرب التي استمرت 8 أعوام، وسفك فيها شلال الدماء!
والاستكبار العالمي هو الذي يحرك القاعدة وداعش -خوارج هذا الزمان- اليوم ضد الإسلام والمسلمين، ومن أجل القضاء على الدولة الإسلامية المباركة، والذي بزوالها ستذهب شوكة المسلمين، بل سيزول الدين الأصيل ويحل محله دين الكافرين!
والاستكبار العالمي سيأتي بعد كل هذه الجراحات التي حلّت بالأمة، وبعد نزف الدماء ودمار الأوطان، وتشرد النساء والرضعان، سيأتي بعد كل هذه الحروب التي ما أبقت حجراً على حجر ودمرت كل مدر، سيأتي وسينقضّ على دول الإسلام ويلتهمها أيما التهام!
هكذا يأملون، كما حصل في زمان الإمام علي (ع): حيث جاء معاوية -رأس الاستكبار الأموي- واستولى على الأمة الإسلامية بعد أن استنزف دولة الإمام الفتية!
فلا خيار لأمّة الإسلام إلا بأن تثبت وتصمد في سوح النزال، وعليها أن تبصر الأعداء وتكشف المؤامرات وتُحسن الاصطفاف، فلا تنخدع بالأسماء والمسميات: كخادم الحرمين وتنظيم دولة الإسلام و…، وتُرسل ببصرها إلى ما وراء هؤلاء الأقزام: لتعرف من يحرك الحروب في الخفاء! ولتدرك أنّهم قد اجتمعوا اليوم كما اجتمعوا بالأمس ضد الإمام علي (ع)؛ فقد تحالف اليهود والنصارى والكفار والمنافقون عليه!
وهكذا اليوم: فإنّ الكفّار واليهود الصهاينة ومعهم رأس النفاق الدعية السعودية، قد وقفوا ضد الإسلام، ووجهوا سهامهم وحرابهم ضد قائد الإسلام، رافع راية المستضعفين، الممهّد لدولة خاتم الأئمة الميامين(عج).
وإذا بالأمس قد خُذل الإمام (ع)، فلا ينبغي اليوم أن يُخذل القائد علي؛ فإنه عزّ الأمّة اليوم، وحاضرها ومستقبلها، متوقف على مدى إظهار النّصرة والولاء وتقديم التضحية والفداء لمثل هذه الراية التي ارتفعت فرفعت أبناء الإسلام!
فإن سقطت أو ضعفت: فإنّ الأمّة الإسلامية سترجع مرة أخرى إلى ذلك الظلام، وستصبح شعوب الإسلام أذل الشعوب بين الأنام!
وهذا ما لا يقبله أبناء الإسلام الكرماء! فارفع الراية عالياً واجعلها خفاقة في السماء عالية .. وسِر يا ابن الأطايب الأنجبين، وسليل آل الرسول الميامين، وخذ بيعة منّي ومن أبناء شعبي، وعهداً إلى أبد الآبدين، أنّا لن نُسلمك ولن نخذلك ولو ذهبنا بأطفالنا ونسائنا قرابين!
تقدم .. فالنصر حليفك، والله معينك، والأمّة من خلفك!
تقدم .. ولا تضع هذه الراية إلى في يد صاحبها، يوم يقوم فيملأ الدنيا قسطاً وعدلاً .. ونحن نقول الحمدلله رب العالمين!
[1] القصص: 83
[2] الزِبْرِجُ: الزينة من وشي أو جوهر
[3] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:49
الخطبة (3) ومن خطبة له (ع) وهي المعروفة بالشقشقية وتشتمل على الشكوى من أمر الخلافة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له!
[4] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:88
الخطبة (50) ومن كلام له (ع) وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن
[5] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:507، الحكمة (215)
[6] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:524، الحكمة (281)
[7] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:103
الخطبة (75) ومن كلام له (ع) لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان
[8] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:47
الخطبة (83) ومِنْهَا [فِي الْمُنَافِقِينَ] يَعْنِي قَوْماً آخَرِين
[9] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:249
الخطبة (173) ومن خطبة له (ع) في رسول اللّه (ص) ومن هو جدير بأن يكون للخلافة وفي هوان الدنيا
[10] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:336
الخطبة (218) ومن كلام له (ع) في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه
[11] الكافي، ج:2، ص:131
[12] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:244
الخطبة (169) ومن خطبة له (ع) عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة
[13] حَبيس: فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وأم المؤمنين كانت محبوسة لرسول اللَّه لا يجوز لأحد أن يمسها بعده كأنها في حياته
[14] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:247
الخطبة (172) ومن خطبة له (ع)
[15] قال أبو الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة: «قد تقدم منا ذكر ما عتب به طلحة والزبير على أمير المؤمنين (ع) وأنهما قالا ما نراه يستشيرنا في أمر ولا يفاوضنا في رأي ويقطع الأمر دوننا ويستبد بالحكم عنا وكانا يرجوان غير ذلك وأراد طلحة أن يوليه البصرة وأراد الزبير أن يوليه الكوفة فلما شاهدا صلابته في الدين وقوته في العزم وهجره الادهان والمراقبة ورفضه المدالسة والمواربة وسلوكه في جميع مسالكه منهج الكتاب والسنة وقد كانا يعلمان ذلك قديما من طبعه وسجيته [….]حالا عنه وتنكرا له ووقعا فيه وعاباه وغمصاه «تهاونا بحقه» وتطلبا له العلل والتأويلات وتنقما عليه الاستبداد وترك المشاورة وانتقلا من ذلك إلى الوقيعة فيه..» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج11، ص:10
[16] الضّبّ: بالفتح ويكسر: الحقد
[17] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:206
الخطبة (148) ومن كلام له (ع) في ذكر أهل البصرة
[18] رسالة الخواص، ص: 91
[19] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:415
الكتاب (43) ومن كتاب له (ع) إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على أردشيرخرة
[20] أقْرِبْ بهم: ما أقربهم من الجهل
[21] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:259
الخطبة (180) ومن خطبة له (ع) في ذم العاصين من أصحابه
[22] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:318
الخطبة (200) ومن كلام له (ع) في معاوية
[23] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:246
الخطبة (172) ومن خطبة له (ع)
[24] الأوَد: الاعوجاج
[25] حَدَجُوا: خلطوا
[26] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:231
الخطبة (162) ومن كلام له (ع) لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به
[27] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:60
الخطبة (17) ومن كلام له (ع) في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل
[28] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:532
[29]نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:119
الخطبة (87) ومن خطبة له (ع) وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة والظن الخاطئ لبعض الناس
[30] شرح نهج البلاغة، البحراني، ج2، ص:350
[31] دَنِقٌ: -كفرح-: كدر
[32] رَدِغٌ: كثير الطين والوحل- والمشرع: مورد الشاربة للشرب
[33] يُوبِقُ: يهلك
[34] حائِل: اسم فاعل من «حال» إذا تحوّل وانتقل
[35] أي لا تكفّ المنية عن اخترامها، أي: استئصالها للأحياء
[36] الاجترام: افتعال من الجرم، أي اقتراف السيئات
[37] نهج البلاغة، صبحي صالح، ص:108
خطبة (83) ومن خطبة له (ع) وهي الخطبة العجيبة تسمى «الغراء»