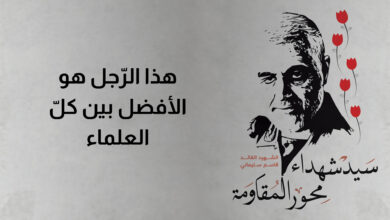عناد آل فرعون ونزول آيات العذاب عليهم

<وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 132 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِين>
قال فرعون الطاغية وقومه الفاسقون، المعينون له على الكفر والباطل والظلم والجور والطغيان، والمتضامنون معه في استضعاف بني إسرائيل واستعبادهم وإذلالهم وعلى مناهضة موسى الكليم (عليه السلام) ودينه وحركته الإصلاحية والثورية، قالوا لموسى الكليم (عليه السلام) في تحدٍ منهم صارخ، وعناد ومكابرة لدينه وما جاء به من المعجزات النيرات الباهرات والبينات الواضحات والبراهين الساطعة القاطعة، وبهدف تأييسه من إيمانهم به وتصديقهم برسالته واتباعهم له: <مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِين>[1]، أي: لا تتعب نفسك معنا وتشق عليها بما تأتي به من السحر، وتحاول أن تأتي بالمزيد مما تدعيه أنها آيات ومعجزات من عند رب العالمين؛ لأننا مصرون على البقاء على ما نحن عليه من الدين الفرعوني والسياسة والاجتماع، وماضون فيه، وثابتون عليه إلى النهاية، ولن نتراجع لك عن شيء من مواقفنا وديننا ونظام دولتنا وسياستنا الفرعونية، ولن نتخلى عن شيء من ذلك، فجدير بك أن تيأس منا، فلن نؤمن بك، ولن نصدقك، ولن نتبعك في شيء مما تدعونا إليه من العقائد والقيم والأحكام والمصالح والسلوك، فقد تقرر عندنا بشكل قاطع ونهائي، أنك ساحر مخادع كذاب، وجزمنا بأن كل شيء تأتينا به على أنه آيات ومعجزات من عند رب العالمين، هو عندنا وفي يقيننا مجرد سحر لا أكثر، تأتي به للتمويه علينا وخداعنا؛ لتصرفنا به عما نحن عليه من الدين والسياسة والنظام الفرعوني ودولته، ولا علاقة له البتة من قريب أو بعيد بما تسميه أنت رب العالمين، الذي لا وجود له، وإن وجد فلا دخل له في حياتنا، فنحن الذين نضع النظام القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والقضائي الذي يناسبنا، ويخدم مصالحنا، ويحقق أغراضنا المادية والمعنوية في الحياة، ولا علاقة لرب العالمين به من قريب أو بعيد.
وعليه: عليك أن تيأس منا فلن نؤمن بك، ولن نصدقك، ولن نتبعك أبداً، مهما حاولت، ومهما جئتنا بأعمال عجيبة خارقة للعادة، بزعم أنها آيات ومعجزات ممن تدعي أنه رب العالمين. أي: أنهم قابلوا الآيات، وما حل بهم من المصائب والبلايا بمزيد من الغرور والعناد، وأنهم مصرون على تكذيبه والكفر بما يدعوهم إليه إلى الأبد، مهما جاءهم بآيات ومعجزات وحجج وبراهين، ولقد قالوا ذلك، وأصروا عليه، رغم أن السحرة وهم أهل الفن المحترفين في السحر، وأصحاب الاختصاص والخبرة فيه، الذين جاؤوا بهم لمبارزة موسى الكليم (عليه السلام) وجعلوهم حجة بينهم وبينه، قد أقرّوا صراحة، وأعلنوا جهاراً بكل جرأة وشجاعة منقطعة النظير في ميدان المبارزة، أمام الجماهير المحتشدة، وبحضور فرعون وملئه وأعوانه وأنصاره وكامل جهازه الأمني والعسكري والسياسي والإداري والفني، بأن ما جاء به موسى الكليم (عليه السلام) ليس من السحر في شيء، ولا مشابه له، وإنما هو آية ومعجزة عظيمة، لها حقيقة فعلية فعالة غير موجودة في السحر، تقف وراءها قوة غيبية مطلقة فوق الطبيعة وفوق طاقة البشر، <وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ>. وقد آمنوا السحرة بنبوة موسى الكليم وأخيه ووزيره هارون (عليهما السلام) ورسالتهما من عند رب العالمين إلى كافة الناس، وأعلنوا ذلك أمام الجماهير في ميدان المبارزة وبحضور فرعون وملئه، ودفعوا حياتهم ثمناً لإيمانهم؛ لفرط يقينهم فيما آمنوا به، وصواب موقفهم الإنساني البطولي العظيم.
لكن فرعون وقومه لم يتبعوا السحرة الكرام المحترفين، الذين جاءوا بهم من جميع المناطق والأنحاء في مصر؛ لكي يبارزوا بهم موسى الكليم (عليه السلام) وجعلوهم حجة بينهم وبينه، ليظهروا حقيقة ما عنده، وما جاء به، ولم يصدقوهم فيما عرفوه من الحق، وأيقنوا به، بل أنزلوا بهم أشد العقوبات، وقتلوهم صبراً بأبشع صور القتل، ونكلوا بهم انتقاماً منهم لإيمانهم بالحق استناداً إلى الدليل والبرهان الساطع القاطع والحجة النيرة الباهرة؛ ولأنهم خرجوا على الدين والنظام الفرعوني، وعلى طاعة فرعون وحكومته، وآمنوا بدين موسى الكليم (عليه السلام) وبرسالته، وعدالة قضيته، وشرعية مطالبه الإصلاحية الدينية والسياسية والحقوقية، وشرعية حركة بني إسرائيل وثورتهم التحررية.
وعليه: فقد ساوى فرعون الطاغية وقومه الفاسقون بين المعجزة والسحر، وبين الحقائق والأوهام، وبين المنطق واللامنطق، وبين الدليل واللادليل، وبين الحق والباطل، وقولهم: <مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِين>[2] الذي جابهوا به موسى الكليم (عليه السلام)، وأصروا عليه، يحمل الكثير من العتو والعناد والمكابرة والسخرية والاستهزاء بموسى الكليم (عليه السلام)، وعدم الاكتراث، وعدم المبالاة بدعوته ومواعظه وإرشاداته وبما جاء به من الآيات الساطعة والبينات الواضحة والمعجزات العظيمة، وسدوا على أنفسهم باب الفهم والهداية، مع اعترافهم بعظمة ما جاءهم به موسى الكليم (عليه السلام)، وبعجزهم عن الرد عليه، ومقابلة الدليل بالدليل والحجة بالحجة، ولجأوا إلى القوة والعنف والإرهاب؛ لإسكات صوت الحق والعدل والخير والفضيلة والعقل والمنطق والهدى والصواب، مما يدل على أنهم لا يبحثون عن الحقيقة والعدالة والخير والفضيلة والحقوق والمصلحة العامة، ولا يقيمون لها وزناً ولا اعتباراً؛ لأن المهم عندهم هي مصالحهم الدنيوية الخاصة فقط ولا غير، كما هو دأب الفراعنة المتجبرين والحكام المستبدين والمترفين المستغلين والانتهازيين الأنانيين والنفعيين الفاسدين في العالم على طول التاريخ وعرض الجغرافيا، ولا يعتقدون بالصلة الوثيقة الوجودية القائمة بين معرفة الحقيقة والعمل بمقتضاها، وبين كمال الإنسان وخيريته ومصلحته الحقيقية في دورة الحياة الكاملة وسعادته الحقيقية الكاملة في الدارين الدنيا والآخرة، بل يفصلون فصلاً تاماً بين حياة الإنسان وواقعه وبين الحقائق في نفسها، ولا قيمة للحقائق في نفسها، ويخضعون حياة الإنسان ومصيره وتدبير شؤونه وكافة أموره العامة، لأهواء الحكام والمنتفعين المهيمنين على مقاليد الأمور ومقدرات البلاد، ولرغباتهم ونزواتهم وشهواتهم الحيوانية وملذاتهم الحسية، وما تقتضيه مصالحهم الخاصة وترتضيه عقولهم السخيفة وإراداتهم الجائرة عن الحق والعدل والخير والفضيلة، وأذواقهم الحسية المنحرفة عن الدين الحق والفطرة والطبع السليم والعقل والمنطق، وذلك منهم بدون حجة ولا برهان صحيح.
وهم في الحقيقة والواقع من الفئة الضالة، الذين قال الله تعالى عنهم: <وَإِن يَرَوْا كُل آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا>[3]، أي: أنهم بلغوا من الكفر والعناد والمكابرة والاستغراق في عالم الدنيا والمادة والأنانية وحب الذات والمصالح الدنيوية الخاصة درجة لا يفيد معهم دليل ولا برهان ولا موعظة من أحد أبداً.
ومن الذين قال الله تعالى عنهم: <وَلَو فَتَحنا عَلَيهِم بابًا مِنَ السماءِ فَظَلوا فيهِ يَعرُجونَ ١٤ لَقالوا إِنما سُكِرَت أَبصارُنا بَل نَحنُ قَومٌ مَسحورونَ >[4]، أي: لو أن الله (عز وجل) مكنهم من الصعود إلى عالم الملكوت الأعلى والمجردات، فرأوا الملائكة الكرام وما فيه من العجائب والآيات والبينات والدلائل الواضحة، التي هي نفس الحقيقة وعينها رؤية عيان ومشاهدة، لقالوا لفرط عنادهم وتعنتهم ومكابرتهم: إنما سكرت أبصارنا، فما رأيناه ليس بحقيقة ولا واقع له، وأننا تعرضنا للسحر وأُصبنا به، فما رأيناه ما هو إلا مجرد أوهام لا حقيقة لها ولا واقع، وسيبقون على عادتهم يجادلون بالباطل واللامنطق؛ ليدحضوا به الحق والمنطق، فهم لا يؤمنون إلا بذواتهم الخبيثة ومنافعهم الدنيوية الخاصة، وعالمهم الوحيد هو عالم الدنيا والمادة والمصلحة، ولا يعترفون بدين أو حقائق أو قيم أو مبادئ أو منطق ولا بشيء من هذا القبيل أبداً، ولا يقيمون وزناً أو اعتباراً.
وقيل: أن عبارة <فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ>[5]، تفيد المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بنبوة موسى الكليم (عليه السلام) وما يدعوهم إليه من الإيمان بعقيدة التوحيد والمعاد والنبوة والأخلاق الكريمة والشريعة الإلهية ونحو ذلك، ودوام هذا الانتفاء.
وقيل: أن لفظ <لَكَ>[6] في العبارة يومئ إلى العامل المؤثر وهو العناد والتعصب والمكابرة، وأن الدافع شخصي لا مبدئي، وهو يكشف عن استعلائهم وتكبرهم، إذ يرون أنفسهم من طبقة عليا حاكمة، ويرون موسى الكليم (عليه السلام) من طبقة سفلى محكومة ومستضعفة، فلا يليق بهم أن يخضعوا لموسى الكليم (عليه السلام) ليتبعوه، بل يجب عليه هو أن يبقى على خضوعه واتباعه وتبعيته لهم، فالمسألة عندهم ليست مسألة حقائق ومنطق، بل مسألة تمييز طبقي موروث لا دخل له بالفكر والأخلاق والسلوك أو نحو ذلك، فسدّوا بهذا النمط من التفكير والمنطق الجاهلي المتعصب والمتخلف على أنفسهم منافذ وطرق الهداية والرفعة الحقيقية والتكامل الإنساني الفعلي والحقيقي، وهذا هو عينه طريق الهلاك والشقاء الحقيقي في الدارين الدنيا والآخرة، وذلك بسبب انفصالهم عن العقل والمنطق وعن الحقائق والسنن الكونية والتاريخية، وعدم سماعهم للمواعظ البليغة والنصائح الصادقة، وسلوكهم طريق الانسلاخ من الإنسانية، مما يعرضهم إلى السخط والمقت الإلهي، والشقاء الأبدي، والعذاب العظيم في الآخرة.
ولن يضروا الله (عز وجل) بشيء من ذلك؛ لأنه الغني المطلق وفي مَنَعَةٍ تامةٍ من كيدهم الخبيث، بل لن يضروا الدعوة الإلهية الحقة، ولن يضروا المؤمنين الصالحين، ولن يوقفوا تقدم الدعوة بكيدهم؛ لأن الله (عز وجل) عالم بكيدهم، وغالب على أمرهم، ولن يفلح الظالمون والكافرون المجرمون في كيدهم ومخططاتهم التي يستهدفون بها الحقيقة والعدالة والدعوة والفضيلة والدعاة المؤمنين الصالحين والمناضلين الشرفاء والمطالبين المخلصين بحقوق الإنسان، ولكنهم للأسف الشديد لا يشعرون بهذا الوبال العظيم عليهم؛ لفرط استغراقهم في عالم الدنيا والمادة والأنانية والمصالح، وانفصالهم عن الواقع وعالم الحقائق والمنطق والقيم والفضيلة.
وقيل: أن لفظ الآية في قولهم <مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَة>[7]، يفيد الاستهزاء والسخرية منهم بموسى الكليم (عليه السلام)؛ لأن موسى (عليه السلام) يصف معاجزه التي يأتيهم بها، بأنها آيات، وهم يصفونها بالسحر، مرادهم: أنك تأتينا بالسحر وتسميه آية ومعجزة، يقول آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: «إن لحن الآيات (القرآنية) والقرائن يفيد أن الجهاز الإعلامي الفرعوني الذي كان – تبعاً لذلك العصر – أقوى جهاز إعلامي، وكان النظام الحاكم في مصر يستخدمه كامل الاستخدام…، إن هذا الجهاز الإعلامي قد عبأ قواه في توكيد تهمة السحر في كل مكان، وجعلها شعاراً عاماً ضد موسى (عليه السلام)؛ لأنه لم يكن هناك تهمة أنسب منها بالنسبة إلى معجزات موسى (عليه السلام) للحيلولة دون انتشار الدعوة الموسوية، ونفوذها المتزايد في الأوساط المصرية»[8].
وقيل: أن اللفظ يدل على اعتراف صريح منهم بأنهم يرفضون الحق، وفي نفس الوقت يعترفون بالعجز عن مواجهته بالحجة والبرهان، فقد توصلوا إلى قناعة عقلية مستقرة في داخل أنفسهم، بأن ما جاء به موسى الكليم (عليه السلام) هي فعلاً آيات إلهية ومعجزات باهرات عظيمة، يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها، ولكنهم يرون أن الدين قضية شخصية موروثة من الآباء والأجداد أو مجرد هوية، وتخضع للاختيار الشخصي البحت وليست ملزمة، ولا علاقة لها بالشأن العام في الحياة وبسلوك الشخص ومواقفه في الحياة العامة.
فكل واحد أو جماعة تختار دينها بنفسها بحسب الموروث، وتجعله هوية لها، أو بحسب ما يوافقها ويناسب مصالحها الدنيوية، وليس بالضرورة يتبعون ديناً واحداً قام الدليل على صحته ووجوب اتباعه، فهم لا يعتقدون بأن للدين قيمة موضوعية في نفسه، ولا يعتقدون بوجود صلة وجودية وثيقة بين الدين الحق وبين نظام الدولة والمجتمع والنظام أو المجتمع الدولي، ولا بينه وبين كمال الإنسان المقدر له وخيره وصلاحه وسعادته الحقيقية في الدارين الدنيا والآخرة.
وهذه هي نظرة الكثير من الناس للدين في العالم على طول التاريخ وعرض الجغرافيا، بل هي النظرة العلمانية السائدة في عالمنا اليوم. وربما يكون بهم ما هو أسوء حالاً من ذلك، بأن يكون إبليس الرجيم قد ركبهم واستولى عليهم بالكامل، فكانوا صورة بشرية له في العناد والمكابرة والعناد والاستكبار والأنانية وتضخم الذات، فإبليس الرجيم كان عارفاً بالله ذي الجلال والإكرام، وقد كلمه (جل جلاله) وحاوره مباشرة وبدون واسطة أحد، وكان على يقين بالمعاد والحساب والجزاء في يوم القيامة، وبالنبوة والخلافة الإلهية للإنسان في الأرض، ووجوب الطاعة لله (عز وجل)، وحرمة معصيته عقلاً حكماً قطعاً.
ومع ذلك كابر الحق وعانده واستكبر عليه وخالفه، وأصر على المعصية وعلى إغواء الإنسان وإضلاله حسداً له من عند نفسه؛ وذلك بسبب الأنانية والحسد وتضخم الذات التي وضعها في مقابل عزة الرب الجليل جبار السموات والأرض، فهلك وأَهْلَك، وشقى وأشقى، وهذا هو حال الكثير من الناس الذين يسلكون طريق الكفر والضلال عن علم ويقين، وهم أشقى عباد الله سبحانه وتعالى.
وقيل: سموها آية على اعتقاد موسى الكليم (عليه السلام) لا على اعتقادهم، أو باعتبار الغرض الذي تحداهم به حين الإتيان بها؛ لأنه كان يأتيهم بها استدلالاً على صدق نبوته ورسالته وصحة ما كان يدعوهم إليه من عقيدة التوحيد والنبوة والمعاد والقيم الإلهية والتشريعات الربانية ونحو ذلك، أي: سايروه وجاروه في ذلك لا اعتقاداً منهم بها.
ورغم ما أظهره فرعون الطاغية وقومه الفاسقون من اللؤم والخبث والعناد والمكابرة والاستكبار، وما جابهوا به ولي الله الأعظم موسى بن عمران الكليم (عليه السلام) من التكذيب والسخرية والاستهزاء والاتهامات الباطلة والتحدي والاصرار على البقاء والاستمرار على ما كانوا عليه من الدين الفرعوني الباطل، وسياسة القمع والعنف والإرهاب والتمييز ضد بني إسرائيل، واستضعافهم وإذلالهم وإخضاعهم للنظام والدولة وسلطة الملك بالقوة وبغير إرادتهم ورضاهم وعلى خلاف مصالحهم، وسلبهم جميع حقوقهم الطبيعية في الحياة، واجتهادهم في تيئيس موسى الكليم (عليه السلام) من إيمانهم بنبوته، وتصديقهم برسالته، واتباعهم له، واقتدائهم به في جميع الأحوال وإلى الأبد مهما جاءهم بالآيات والمعجزات والبينات والبراهين، وأصدروا حكمهم النهائي الحاسم القاطع فيه، أنه ساحر مخادع كذاب ومتآمر على الملك والحكومة والدولة والنظام والشعب، يريد إسقاط الدولة والنظام وإقصاء أنصار فرعون عن الوظائف العليا والمناصب الرئيسية في الدولة، وإخراج الأقباط من أرضهم وديارهم ووطنهم من أجل أن يستأثر مع بني إسرائيل والمؤمنين به بالسلطة والثروة والمقدرات.
مع ذلك كله فإن الله (جل جلاله) برحمته الواسعة، لم يدعهم ولم يتخلَّ عنهم، وعمل بكل وسيلة حكيمة من أجل إيقاظهم وهدايتهم بدون أن يسلبهم الخيار؛ لأن سلبهم الخيار خلاف الحكمة وخلاف غاية خلق الإنسان وتميزه بين الكائنات في الوجود بأسره، قول الله تعالى: <إِن نشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ السمَاءِ آيَةً فَظَلتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ>[9]، أي: إن نشأ ننزل عليهم آية إلهية أو معجزة سماوية عظيمة مذهلة، تدل على تهديدهم بالإهلاك تهديداً محسوساً، وجعل تنزيل الآية من السماء أوضح وأشد تخويفاً، فتخضعهم وتجبرهم على قبول الإيمان والهداية، فتصبح أعناقهم خاشعة منقادة لها بالكره منهم، ولكنا لم نشأ ذلك؛ لأنه لا مصلحة فيه، وغير نافع، ومخالف للحكمة الربانية ولغاية خلق الإنسان وتميزه بين الكائنات في الوجود بأسره بالعقل والاختيار، وإرادتنا بمقتضى الحكمة هي أن يسلك الإنسان طريق الإيمان والهداية والحق عن نظر وإرادة واختيار ورضا، وليس عن طريق القهر والغلبة ولو بقوة سماوية غيبية؛ لأنه لا فضل له في إيمان يجبر عليه، ولا يستحق عليه الأجر والثواب، ولو شاء الله (عز وجل) ذلك، لجعله في أصل خلقته.
وقد تكفلهم الله (جل جلاله) بنفسه، وأراد أن يبالغ في إقامة الحجة البالغة والتامة عليهم؛ ليضعهم بشكل حاسم بين طريقين لا ثالث لهما: طريق الهداية الحق واتباعه استناداً إلى الدليل والبرهان القاطع، وطريق الهلاك والشقاء الأبدي الكامل بعد إقامة الحجة البالغة المقامة عليهم، أي: أعطاهم الفرصة النهائية للاختيار بين الهداية والسعادة، وبين الضلال والشقاء، بعد أن تمادوا في عنادهم ومكابرتهم وبلغوا حداً من الكفر والطغيان والفساد والانحراف في الأخلاق والسلوك والمواقف الإجرامية. وليس من الحكمة السكوت عنهم، حيث أصبح استمرار وجودهم وبقاؤهم في الحياة مع ما هم عليه يشكل خطراً جدياً على البشرية ومسيرة تكاملها الروحي وتقدمها الإنساني، وهو أمر مخالف للحكمة الإلهية البالغة القاضية بإرادة الهداية والسعادة للبشرية وإيصالها إلى كمالها اللائق بها والمقدر لها في أصل الخلقة والتكوين، وتوفير أسبابها، وإزالة الموانع التي تحيل دونها. ومخالف للعدل الإلهي القاضي بأن لا يترك المستضعفين ألعوبة بيد المستكبرين الظالمين، يتحكمون في مصائرهم بشكل مطلق، ويسومونهم سوء العذاب، ولا حول ولا قوة للمستضعفين في مواجهتهم، والتخلص من جورهم وظلمهم وأذاهم. ومخالف للرحمة الإلهية بالمؤمنين المطيعين لله سبحانه وتعالى وللرسول الكريم (عليه السلام) بأن يتركهم تحت رحمة الطواغيت الضالين المتجبرين، يتحكمون فيهم، ويؤذونهم، ويضعون الصعوبات والعقبات أمام حريتهم في الدين والعبادة والطاعة لله (جل جلاله) والرسول الكريم (عليه السلام) والعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى.
وقد جرت السنة الإلهية على أن يبعث الله تبارك وتعالى بالرسل مبشرين ومنذرين، ويزودهم بما يثبت صدق نبوتهم ورسالتهم من الآيات والمعجزات والبينات والبراهين الساطعة، وأن يضمن بقاء الرسالة واستمرار وجودها، وتمكن الناس من الوصول إليها سليمة صحيحة في دورتها الرسالية، وأن يزيل كل خطر يهدد بقائها واستمرار وجودها في هذه المدة «الدورة الخاصة بها»، ويزيل كل عقبة تمنع من وصولها إلى الناس، بما في ذلك اِهلاك الأقوام الذين ينتج عن بقائهم وقوتهم قطع الطريق على العباد إلى الهداية، كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح ولوط وغيرهم؛ لأن استمرار بقائهم يساوي في النتيجة الامتناع عن بعث الأنبياء والرسل، وهو خلاف الحكمة الإلهية؛ لأنه يدل على عبثية الخلق، وخلاف مقتضى العدل الإلهي والرحمة الإلهية بالمؤمنين، ولا يكون إلا عن عجز القدرة الإلهية، وهو أمر لا يقبله العقل والمنطق سبحان الله عما يصفون، فالله (عز وجل) قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وهو غالب على أمره غير مغلوب.
وعليه: فإن الله (عز وجل) بعد أن لم تنفع الآيات السابقة، القحط والجدب ونقص الثمرات، وما ترتب عليها من الأضرار البليغة في الأموال والأنفس والمعنويات في إيقاظ آل فرعون، وتنبيههم من غفلتهم، وإعادتهم إلى عقولهم ورشدهم، أنزل الله (عز وجل) عليهم عقوبات وشدائد متعددة أعظم من سابقتها، وأكثر تدميراً.
فقد أرسل على فرعون وقومه الأقباط الموالين له والمُعينين له على الظلم والجور والطغيان والفساد والمتابعين له في دينه والراضين بسياسة التمييز والعنف والإرهاب والاستضعاف والإذلال لبني إسرائيل خمس آيات بينات، قول الله تعالى: <فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ>[10]، وقد أرسلها عليهم متفرقة غير متصلة، قوله: <آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ>[11]، أي: منفصل بعضها عن بعض، بين كل واحدة منها والأخرى فواصل زمنية؛ لأن حقيقة التفرقة، هي الفصل بين شيئين بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر.
وقيل: كان امتداد كل واحدة من الآيات أسبوعاً، وما بين الواحدة والأخرى شهراً. وقيل: ستة أشهر. وقيل: سنة كاملة.
وذلك بهدف إيقاظهم من غفلتهم البالغة وتنبيههم من سباتهم العميق، ولكي تكون هناك فرصة زمنية كافية للتأمل والتفكير والمراجعة والتصحيح؛ لأن الغاية ليست العقاب من أجل العقاب، وإنما العقاب من أجل التنبيه والإيصال إلى الهداية وتحصيل السعادة الحقيقية الكاملة للإنسان.
كما يستعار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط في المعاني، ولهذا قيل: أن المراد هو الفصل المجازي وهو إزالة اللبس، والمعنى في قوله: <آيَاتٍ مُّفَصَّلَات>[12]، أي: آيات لا شبهة لمن نظر نظرَ تفكرٍ واعتبار في كونها معاجز عظيمة باهرة من عند رب العالمين.
وقيل: الفاء في عبارة: <فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ>[13]، لتصريح إصابتهم بهذه المصائب والشدائد والمحن والنكبات على عتوهم وعنادهم ومكابرتهم على الحق وأهله، ولفظ: <عَلَيْهِمُ> دال على أن جملة أرسلنا مفرعة تفريع العقاب لا تفريع زيادة الآيات والمعجزات والبينات.
وقد أخبرهم نبي الله الكريم موسى الكليم (عليه السلام) بحدوث هذه الآيات قبل مجيئها؛ لتكون دليلاً على صدق نبوته ورسالته، فيتركوا ما كانوا عليه من الكفر والضلال والظلم والجور والطغيان والفساد والعناد والمكابرة والاستكبار، ويؤمنوا بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ويؤمنوا برسوله الصادق الأمين، ويتبعوه، ويقتدوا به، ويؤمنوا بالآخرة ويعملوا من أجلها، ويخرجوا من الاستغراق في عالم الذات والدنيا والمادة والمصالح الخاصة، وينجوا من هلاكها وعذابها.
ولكي لا يفسروا الآيات والمعجزات تفسيراً تعسفياً منحرفاً بحسب أهوائهم وأمزجتهم وما تمليه عليهم شهواتهم الحيوانية ونزواتهم وملذاتهم ومصالحهم الخاصة بعيداً عن الحقائق والعقل والمنطق والبرهان الصحيح، كأن ينسبوها إلى عمل الطبيعة وحدها، ويقولوا: هذه ظواهر طبيعية حدثت لأسباب طبيعية بحتة، ولا علاقة لها برب العالمين الذي يدعيه موسى الكليم (عليه السلام)، ولا بتكذيبهم له ورفضهم لنبوته ودينه ورسالته بدون حجة أو برهان، ولا بسياستهم وما يوقعوه من التمييز والظلم والجور والاستضعاف والإذلال لبني إسرائيل، ولا بأخلاقهم القبيحة المذمومة وسلوكهم المنحرف ومواقفهم الجائرة عن الحق والعدل والخير والفضيلة وجرائمهم الشنيعة البشعة ضد الأبرياء والأولياء والصالحين وما ينشرونه من الفساد في الأرض.
روي أن موسى الكليم (عليه السلام) دعا عليهم، فقال: «رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا، وإن قومه قد نقضوا عهدك، فخذهم بعقوبة تجعلها لهم ولقومي عظه، ولمن بعدهم آية وعبرة»[14]، وفي رواية أخرى أنه قال: «يا رب إن عبدك هذا (يعني فرعون) قد علا في الأرض، فخذه بعقوبة تجعلها له ولقومه نقمة، ولقومي عظة، ولمن بعدي آية»[15]، فاستجاب الله (عز وجل) دعوته، فبعث عليهم أول الأمر الطوفان، وهو الماء العظيم المتناهي في الكثرة والسيل المغرق الذي يغمر جهات كثيرة ويطغى على المنازل والمزارع ونحوها، أرسله عليهم من السماء مطراً عظيماً، وتحول إلى سيول جارفة عمت مناطق سكنهم وزرعهم ومصانعهم وأسواقهم، فأغرقت الزرع وأهلكت الماشية، ودخلت إلى بيوتهم، فملأتها بالماء والطين وخربتها، وركد الماء على أراضيهم فلم يقدروا على حرثها وإصلاحها ولا غير ذلك من الأعمال العمرانية ونحوها، فألحق ذلك بهم أضراراً بالغة في الأنفس والأموال والممتلكات.
وقيل: أنهم مُطِروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يرون شمساً ولا قمراً، ولا يقدر أحدهم أن يخرج من داره، حتى كادوا أن يهلكوا.
وقيل: أصابهم الطاعون، وانتشرت بينهم الأوبئة والأمراض، ومات منهم خلق كثير.
وقيل: أصابهم ثلج أحمر لم يروا مثله من قبل، فمات منهم فيه خلق كثير، وجزعوا، ففزعوا إلى موسى الكليم (عليه السلام)، فقالوا: ادع لنا ربك أن يكشف عنا، ونحن نؤمن بك ونتبعك، فدعا، فكُشِفَ عنهم العذاب، فما آمنوا، ولم يتعظوا، ولم يكفوا عن تعنتهم وعنادهم.
وقيل: نبت لهم في تلك السنة من الكلأ والزرع ما لم يعهد مثله كثرة ووفرة، ثم بعث الله (عز وجل) عليهم بعد فترة من الزمن الجراد، وهي الحشرات المعروفة التي تغزو الأشجار والنباتات وتأكلها، فكثُرت عليهم، ووقعت على كلأهم وعامة زرعهم وثمارهم وأشجارهم أكلاً وقضماً وإتلافاً حتى أفرغتها من جميع الأغصان والأوراق.
وكان هجوم أسراب الجراد عليهم عظيماً جداً، حتى وصلت الآفة إلى حد أكل الجراد الأبواب والثياب والأمتعة، وخربت سقوف المنازل، وأخذت تؤذي أبدانهم، حتى تعالت صيحاتهم واستغاثاتهم لشدة ما أصابهم من الأضرار والأذى، ففزعوا إلى موسى الكليم (عليه السلام)، فدعا، فكُشِفَ عنهم العذاب، فما آمنوا، ولم يتعظوا، ولم يكفوا عن تعنتهم وعنادهم وكفرهم وطغيانهم وفسادهم في الأرض.
فبعث الله (عز وجل) عليهم بعد فترة من الزمن القُمّل، وهي حشرة طفيلية صغيرة لا أجنحة لها، تتولد عادة من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو ريشاً أو شعراً مع عفونة ودهونة، وتلسع الإنسان بعضتها، وتتغذى على دمه، وتسبب إليه الأمراض، وتنقلها منها إليه. وقد أصابهم القمل، وانتشر بينهم، وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده، فيعضه، ويتغذى على دمه، وأخذ شعرهم وأبشارهم وأشعار عيونهم وحواجبهم، ولزم جلودهم، كأنه الجدري، ومنعهم من النوم والقرار. وكان أحدهم يأكل الطعام فيتساقط فيه القمل فيملأه. وأصاب القُمّل دوابهم، وساهم في نشر الأمراض والأوبئة بينهم.
وهناك قُمّل الزرع، وهو شر ما يكون وأخبثه، وهو دويبة صغيرة تطير كالجراد إلا أنها ليست بجراد، يقع على الزرع، ويأكل السنبلة وهي غضة طرية قبل أن تكتمل، فتبع حرثهم وأشجارهم ونباتهم فأضر بزرعهم كثيراً.
وقيل: أتى على زروعهم كلها واجتثها من أصلها، فذهبت زروعهم ولحس الأرض كلها، وكانت الحصيلة أن أصابهم الجوع وانتشرت فيهم الفاقة الشديدة، ففزعوا إلى موسى الكليم (عليه السلام)، فدعا فكُشِفَ عنهم العذاب، فما آمنوا، ولم يتعظوا، ولم يكفوا عن تعنتهم وعنادهم وكفرهم وطغيانهم وفسادهم في الأرض.
فبعث الله (عز وجل) عليهم بعد فترة من الزمن أنواعاً مختلفةً من الضفادع الصغيرة والكبيرة، وهي حيوانات برمائية صغيرة، تمشي على أربع أرجل، وتسبح في الماء، وتكون في الغدران ومناقع الماء، صوته مثل القراقر، يسمى: نقيقاً، فكثرت عليهم وامتلأت منها بيتوهم وأفنيتهم.
وكانت تدخل في فرشهم وبين ثيابهم وفي أطعمتهم، وكانت تلقي بنفسها في القدر وهي تغلي، فتفسد طعامهم، وكانت تلقي بنفسها في التنور فتطفي نيرانهم، إلى غير ذلك من أصناف البلاء الذي أصابهم بسبب الضفادع، فأقلقتهم وآذتهم أذيةً شديدةً، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ففزعوا إلى موسى الكليم (عليه السلام)، وقالوا: ارحمنا هذه المرة، ونتوب ولا نعود، فأخذ عليهم العهود، ودعا فكُشِفَ عنهم العذاب، فما آمنوا، ولم يتعظوا، ولم يكفوا عن تعنتهم وعنادهم وكفرهم وضلالهم وطغيانهم وفسادهم في الأرض.
فبعث الله (عز وجل) عليهم بعد فترة من الزمن الآية الخامسة والأخيرة، وهو الدم. قيل: سال النيل عليهم وصار لونه كلون الدم، بحيث تعيفه الطباع الآدمية، فما كانوا يستقون من الأنهار والآبار إلا بلون الدم العبيط الأحمر.
وقيل: كان القبطي يرى ماء النيل بلون الدم، ويراه الإسرائيلي بلون الماء العادي، فإذا شربه الإسرائيلي كان ماءً، وإذا شربه القبطي كان بلون الدم، حتى ذاقوا من الله (عز وجل) العذاب الشديد.
وقيل: أصابهم مرض الرعاف، وهو نزول الدم من الأنف، حيث شاع بينهم كداء عام، وأصيبوا به جميعهم.
وكلها – الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم -، آيات بينات من عند رب العالمين، أرسلها على فرعون الطاغية وقومه الأقباط الفاسقين، الموالين له، والمتابعين له في دينه، والمناصرين له على ظلم واستضعاف وإذلال بني إسرائيل؛ لكي يتعظوا ويفيقوا من غفلتهم، ويستيقظوا من سباتهم العميق، ويعودوا إلى عقولهم ورشدهم وضمائرهم، فيؤمنوا بالدين الإلهي الحق، ويتبعوا الرسول الكريم (عليه السلام) ويقتدوا به، وكان بنو إسرائيل في عافية من جميع ذلك، بسبب إيمانهم وطاعتهم للرسول الكريم (عليه السلام).
وفسر بعضهم ذلك بالإعجاز الإلهي، وفسره آخرون تفسيراً طبيعياً؛ لأن مناطق سكن بني إسرائيل منفصلة عن مناطق سكن الأقباط ومناطق زراعتهم ومصانعهم وأسواقهم، إذ كانت مناطق الأقباط السكنية والزراعية والصناعية والتجارية على ضفاف نهر النيل، حيث الخصوبة والجمال ورغد العيش، ومعظم الآيات المذكورة الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، لها علاقة وثيقة بكون مناطق الأقباط قريبة من نهر النيل العظيم، فالطوفان والضفادع يأتيان من النيل، والجراد له علاقة بالزراعة، وهي تقوم على مياه النيل ونحو ذلك، أي: تحول سبب النعيم والرخاء ورغد العيش إلى سبب للشقاء والضيق والعذاب الشديد، بينما يسكن بنو إسرائيل في المناطق البعيدة عن النيل.
وهذا التفسير يمكن القبول به جزئياً وليس كلياً؛ لأن الطوفان كان سببه الرئيسي الأمطار الغزيرة جداً وليس فيضان النيل، وفيضان النيل كان بسبب الأمطار الغزيرة جداً. ولأن حياة بني إسرائيل مختلطة مع حياة الأقباط رغم انفصال مناطق سكنهم على العموم، وعليه: لا يمكن الاستغناء عن التفسير الغيبي «الإعجاز» للتمييز بين بني إسرائيل وبين الأقباط في العقوبات الإلهية.
وقيل: سميت آيات، لأنها دلائل على صدق موسى الكليم (عليه السلام) وعلى غضب الرحمن على فرعون وقومه، بسبب عنادهم ومكابرتهم واِصرارهم على الكفر والظلم والطغيان والفساد في الأرض؛ ولأنها اِقترنت بالتحدي. وكانت جميع الآيات ظاهرة الدلالة والوضوح لكل عاقل ينظر نظرَ فكرٍ واعتبار بالتالي:
أ. بأنها مقصودة ومدبرة بيد علية قديرة، لا سيما مع إخبار موسى الكليم (عليه السلام) عنها قبل حدوثها، وليست جزافية أو اِتفاقية أو صدفة أو راجعة إلى محض عمل الطبيعة أو نحو ذلك من التفسيرات المادية التعسفية المنحرفة، بل هي آيات إلهية ونقمات من رب العالمين.
ب. إن فرعون وقومه جميعاً على باطل وضلال في دينهم وسياستهم ونظام دولتهم، وأن ما جاء به موسى الكليم (عليه السلام) حق وهدى وصدق، وفيه خير وصلاح ومصلحة العباد وكمالهم وسعادتهم الحقيقية الكاملة في الدارين الدنيا والآخرة، وأنه جاء به من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس من عند نفسه.
وقد مكث موسى الكليم (عليه السلام) في آل فرعون والأقباط بعد ما غلب السحرة وانتصر عليهم ما يقرب من عشرين سنة، يريهم الآيات والمعجزات والبينات، ويدعوهم إلى الحق والتوحيد والعدل والصلاح والخير والفضيلة، وينهاهم عن الباطل والشرك والظلم والطغيان والفساد والشر والرذيلة، فما آمنوا، ولم يتعظوا، ولم ينتهوا عن فحشاء أو منكر.
وقد جعل الله (عز وجل) بين الآيات فواصل زمنية كبيرة، يمتحن فيها أحوالهم، أيوفون بما وعدوا به أنفسهم أم ينكثون، وبرجاء إيمانهم وهدايتهم إلى الدارين الدنيا والآخرة، إذ تتوفر لهم الفرصة الزمنية الكافية، والدافع القوي للتفكير والتأمل والمراجعة والتصحيح، قوله تعالى: <لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَة>[16]. وذلك إلزاماً وإتماماً للحجة الإلهية عليهم، فكيف كانت النتيجة بعد كل هذه الآيات الإلهية، والبينات الظاهرات، والبلايا والمصائب التي نزلت عليهم، وحلت بساحتهم؟
الجواب: أنهم لم يعتبروا، ولم يتعظوا ولم يذعنوا للآيات والبينات، ولم يستجيبوا لدلالاتها القاطعة، وترفعوا عن قبول الإيمان بالدين الإلهي الحق، ولم يتراجعوا عن شيء مما كانوا عليه من الدين الفرعوني، وسياسة التمييز، والظلم والطغيان، والاستضعاف والإذلال لبني إسرائيل، ونشر الفساد والرذيلة في الأرض، وعتوا واستكبروا، ولم يخضعوا للحق ولم يسلموا للدليل الصحيح القاطع.
وقيل: الفاء في عبارة <فَاسْتَكْبَرُوا>[17] للتفريع والترتيب، بمعنى: فتفرع إرسال الطوفان وما بعده من الآيات استكبارهم، كما تفرع على أخذهم بالسنين غرورهم، بأن قالوا ذلك من شؤم موسى الكليم (عليه السلام) ومن معه من المؤمنين، مما يدل على ضعف عقولهم، وفساد منطقهم؛ إذ انتزعوا المدلولات من أضداد أدلتها، وذلك بسبب استغراقهم في عالم الدنيا والمادة والمصالح الدنيوية، وفرط عتوهم وعنادهم وانغماسهم في البغي والضلال والخذلان والشقاء، وبعدهم عن عالم النور والحقائق والهداية والتوفيق والتسديد والسعادة، فكانوا بحق وحقيقة قوماً مجرمين فاسدي الطبع والفطرة، لا يهتدون إلى حق ولا يتورعون عن باطل، ولا تنفع معهم آية أو رواية أو دليل أو برهان أو موعظة أو نصيحة صادقة أو نحو ذلك، فقد ختم الله (جل جلاله) على قلوبهم وعقولهم، فهم لا يفقهون حجة أو دليل أو برهان، وعاقبهم على سوء اختيارهم، بأن أبقاهم على الغي والضلال.
وقيل: صيغ الخبر عن إجرامهم بصيغة الجملة الإسمية في قوله تعالى: <وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِين>[18] للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم وتمكنه منهم، وأنه علة استكبارهم، فلا حل لمعضلتهم إلا بإفنائهم وإهلاكهم عن آخرهم، وتخليص البشرية من شرهم وأذاهم، وفتح الطريق أمام كل من يطلب الحقيقة والهداية والسلام والوصول إليها.
وتعبير <قَوْمًا مُّجْرِمِينَ>[19]، يدل على أن كل من يستغرق في ظلام الدنيا والمادة والمصالح الدنيوية الخاصة، وينسى الله ذي الجلال والإكرام والآخرة، يتحول بالضرورة إلى شخص مجرم بحق وحقيقة، ويكون مستعداً لارتكاب كل جريمة فردية أو جماعية، صغيرة أو كبيرة، متى اقتضت مصلحته ذلك وتمكن منها، وكان آمناً من العقاب؛ إذ لا رادع يردعه عن الجريمة والذنب والمعصية؛ لأن المصدر الوحيد الواقعي والمنطقي للقيم العليا والمبادئ السامية والردع عن الجريمة، هو الإيمان الواعي العميق بالتوحيد والنبوة والمعاد، متى قطع الإنسان صلته بالإيمان قطع صلته بالمصدر الوحيد الواقعي والمنطقي للقيم العليا والمبادئ السامية وتحرر منها، ولأن التعلق بعالم الدنيا والمادة لا يولد إلا مثله من الشرور والفساد والخراب والدمار في الأرض، وهو غريب تمام الغربة عن القيم العليا والمبادئ السامية التي هي سر إنسانية الإنسان وخيريته وكماله، فكل من تعلق بعالم الدنيا والمادة يكون بين حالتين، أن يكون شيطاناً يتبع الأهواء ويمارس القتل والفتك والفساد في الأرض، أو يكون بهيمة يجري وراء الشهوات والملذات الحسية، وهذا ما كشفت عنه التجارب التاريخية والمعاصرة.
المصادر والمراجع
- [1]. الأعراف: 132
- [2]. نفس المصدر
- [3]. الأنعام: 25
- [4]. الحجر: 14-15
- [5]. الأعراف: 132
- [6]. نفس المصدر
- [7]. نفس المصدر
- [8]. تفسير الأمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 5، صفحة 110
- [9]. الشعراء: 4-
- [10]. الأعراف: 133
- [11]. نفس المصدر
- [12]. نفس المصدر
- [13]. نفس المصدر
- [14]. معجم مجمع البحرين، الطريحي مادة طوف
- [15]. الكشاف، الزمخشري، جزء1-2، صفحة 440
- [16]. الأنفال: 42
- [17]. الأعراف: 133
- [18]. نفس المصدر
- [19]. نفس المصدر